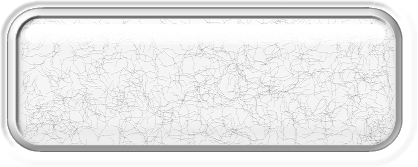تعيش غزة اليوم وشعبها محنة حقيقية تجمع بين الحرب الغاشمة والحصار الطويل تذكر بأيام النكبة الأليمة عام 1948 وتجددها. وتدفع غزة وشعبها في وقت واحد ثمن الاستمرار في مقاومة المخططات الإسرائيلية والغربية، واحتداد التنافس بين الزعامات الإسرائيلية قبل الانتخابات التشريعية القريبة، وانهيار التضامن العربي، وانسحاب العرب من ساحة المواجهة، وتلاعب الدول العربية والإسلامية بالقضية الفلسطينية واستخدامها مصدرا للتعويض عن فقدان أنظمتها الشرعية السياسية، وأزمة الحركة الوطنية الفلسطينية، وتجاهل قادة حماس قوانين السياسة الإقليمية والدولية، وضياع الرأي العام العربي وتشتت فكره، وبحثه عما ينفس عن كربه أكثر من مطالبته بخطة منظمة ورؤية واضحة للعمل الوطني، تمكنه من الحكم على سلوك القوى السياسية على أساس مقدرتها على تحقيقها أو السير بها خطوات ولو صغيرة إلى الأمام.
باختصار غزة تدفع ثمن الأزمة المأساوية الأيديولوجية والسياسية والوطنية التي تعيشها الأمة العربية بأكملها، وفي مقدمتها الحركة الوطنية الفلسطينية. وهي بضعفها السياسي والإستراتيجي والاقتصادي تجذب جميع الأطراف للعب على ساحتها، وتنفيس تناقضاتها فيها، وخوض معاركها السياسية والرمزية على أرضها، بما في ذلك أطراف عربية وأجنبية، كما كان لبنان في فترة سابقة. 2- أما هدف الحرب الإسرائيلية الراهنة فهو توجيه ضربة قوية تزعزع سلطة حماس في غزة وتدفعها إلى الترنح والسقوط إذا أمكن، وذلك من خلال قصف مواقع السلطة ومؤسساتها، واستهداف المدنيين ليثوروا على هذه السلطة.
والغاية من ذلك هي بالتأكيد وضع حد لمقاومة الاحتلال، وفرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني، في غزة والضفة على حد سواء.
لكن في سياق ذلك، تمتحن إسرائيل في هذه الضربة إرادة الدول العربية، وأين وصلت حدود تراجع تضامنها مع القضية الفلسطينية، وتستبق استلام الرئيس الأميركي السلطة في واشنطن بوضع قواعد للعبة في المنطقة تظهر فيها على أنها اللاعب الوحيد والقادر، وأنه لا يوجد للعرب وزن وليس هناك أي ضرورة لأخذهم بالاعتبار في تحديد سياسات واشنطن المقبلة في الشرق الأوسط.
وهي تمتحن أيضا قوة اتفاق الشراكة المعززة الذي وقعته يوم 16 ديسمبر/كانون الأول 2008 مع أوروبا وتحولت بموجبه إلى ما يشبه العضو الكامل في الاتحاد الأوروبي، وهو ينص على التعاون والحوار والتفاهم في مسائل عديدة ومنها المسائل الأمنية.
3- لن تستطيع الحملة العسكرية الإسرائيلية أن تقضي على حماس وسلطتها في غزة، وربما عززتها. إنما ليس هناك شك في أنها ستدمي شعب غزة وتساهم بشكل أكبر في تفكيك العالم العربي وتعميق الشرخ بين أعضائه ومحاوره، وتزيد الشك واليأس والإحباط عند الشعوب العربية، وتدفع إلى تفريغ العالم العربي ككل -حكومات وشعوبا- بصورة أكبر من ثقله النوعي، حتى يبدو عالما ضعيفا مفككا مشتتا تحكمه النزاعات والمشاحنات والمشاعر السلبية واليأس، لا يستحق الاعتبار ولا يؤخذ لأقواله وأفعاله حساب. وهذا ما يساهم أكثر في تدهور الموقف العربي فوق تدهوره، ويفاقم من الأزمة السياسية والفكرية والوطنية التي يعيشها منذ عقود.
4- للأسف في كل مناسبة من هذا النوع، أي أمام ضربات إسرائيل المتعاقبة على مناطق أو قوى أو شعوب عربية، تعود الشكوى من ضعف الموقف العربي كلازمة لا بد منها.
كما لو أننا لا نزال غير مقتنعين بأن روح التضامن العربي القديمة قد زالت تماما، على الأقل في أوساط النخب والسلطات الحاكمة، وأننا لا نزال غير مدركين أنه لا تضامن سياسيا ممكنا من دون تفاهم مسبق أو رؤية مشتركة تجمع بين المتضامنين.
والقصد من هذا الكلام أن التضامن بالمعنى السياسي -وما بالك بالمعنى العسكري- ليس مزروعا في الدم والمشاعر، وإنما يبنى بالعمل السياسي والدبلوماسي بين القوى المختلفة، حتى عندما تكون من أسرة واحدة، ولا يقوم إلا على أسس واضحة تجعل المتضامن يشعر بمصلحته في دعم شريكه، وتعمق إدراكه بأن تخاذله عن دعم حليفه لا يسيء إلى هذا الأخير فحسب وإنما يرتب خسائر سياسية وإستراتيجية عليه هو أيضا. والحال أن ضرب هذا التضامن السياسي العربي وإزالة فكرته من الوجود هو اليوم أحد محاور سياسة الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط. وبالتالي فإن الأنظمة التي تمتنع عن إظهار هذا التضامن أو تعطله لا تخسر وإنما تربح دعما إضافيا أو على الأقل تضمن استمرار الدعم الغربي لها.
بالتأكيد يثير هذا الموقف الرأي العام العربي، بيد أن الأنظمة الحاكمة لا تعبأ اليوم بالرأي العام العربي، لأنها ببساطة لا تدين له بوجودها في الحكم واستمرارها في السلطة، وإنما تدين في ذلك لدعم المعسكر الغربي -الأوروبي الأميركي- وتأييده وتغطيته السياسية والإستراتيجية، وهو الذي تأخذه في الاعتبار وليس رأي الجمهور العربي الذي اعتادت أن تواجهه بالعنف أو بالتلاعب أو بالتنفيس العاطفي.
5- لا تختلف مصر في هذا عن باقي الدول العربية، وبالرغم من أن لمصر مسؤوليات إضافية بوصفها الدولة العربية الأكبر والمتاخمة لغزة التي ترتبط بها بروابط جغرافية وبشرية قوية، فإنها ليست الوحيدة المسؤولة عن تقويض أسس التضامن العربي الذي يشكل وحده ورقة يمكن الرهان عليها لإجبار إسرائيل على أخذ المطالب الفلسطينية بالاعتبار.
وليس هناك من بين الحكومات العربية حكومة واحدة أظهرت في العقدين الأخيرين انشغالها بتطوير التضامن العربي أو حتى الحفاظ عليه، وٌقامت بالحد الأدنى من التضحيات المطلوبة لاستيعاب تناقضات العالم العربي ومصالحه المتعددة والمتضاربة وسعت إلى تذليلها وتجاوزها.
بالعكس، لقد تنافست الأنظمة في التحلل من ارتباطاتها والتزاماتها العربية الجماعية، وقام كل نظام بتحميل المسؤولية على النظام الآخر ليبرر موقفه ويعززه أمام رأيه العام.
وهكذا عمل الجميع -كل بطريقته وأسلوبه وخطابه الخاص- على تعميق الشرخ داخل أقطار العالم العربي، بما في ذلك داخل الصف الفلسطيني نفسه.
من هنا ينبغي في نظري أن نحمل جميع الأنظمة العربية المسؤولية الجماعية عن تحطيم التضامن السياسي العربي، وإفراغ الفكرة العربية نفسها من مضمونها، والانكفاء نحو إستراتيجيات قطرية عن سابق إدراك وتصميم. جميع الأنظمة بوسائلها وحسب رزنامتها الخاصة، تستثمر تحطيم التضامن العربي وقتله لتحسين علاقتها بالكتلة الغربية، وكلها في نظري شريك في الجريمة.والقصد من ذلك أنه لا ينبغي أن نراهن منذ الآن على أي موقف عربي إيجابي، أي مجاني. ولا جدوى ولا فائدة من الندب المستمر ومن مناشدات لا تقوم إلا بتعميق إحباط الجمهور العربي ويأسه وقنوطه.
وبالمثل، ليس هناك أي أمل في أن يتخذ المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، أي قرار يردع الاحتلال ويحد من إرادة العدوان أو تشتم منه حتى رائحة الإدانة الحقيقية لإسرائيل.
6- نستنتج من هذا أن القضية ترجع إلينا نحن، أي إلى مقدرتنا على التعامل داخل محيط إقليمي متخاذل أو مشلول الإرادة، وبيئة دولية ضالعة مع الاحتلال أو غير مكترثة بنا.
وعلينا نحن أن نفكر كيف ننقذ رهاناتنا الوطنية ونعمل من أجل الخروج من الحصار المادي -لكن أيضا السياسي والإستراتيجي- المفروض علينا، وهو الأهم.
ويبدو لي أن الوقت قد حان للاعتراف بأن جوهر المأساة التي نعيشها قائم في أزمة الحركة الوطنية الفلسطينية والتي تتجلى عبر انقسامها السياسي الخطير، وترهل القسم الأكبر من إطاراتها السياسية والقيادية القديمة، وتراجع فاعلية مؤسساتها وتنظيماتها المختلفة، وتشوش تفكيرها.
وربما كان التعبير الأوضح عن هذه الأزمة انفراد حماس بالسلطة في غزة، وانكفاء فتح على الضفة الغربية، ودخول الطرفين في محاور إقليمية ودولية متنازعة للدفاع عن أنفسهما والحفاظ على سلطتيهما، أي على الانقسام الفلسطيني.
وكان من المتوقع -كما حصل بالفعل- أن تستقطب غزة في السنتين الماضيتين نقمة القوى الإقليمية والدولية المعادية للمحور الذي تنتمي إليه حماس، وأن يصبح الصراع على السيطرة عليها جزءا من الصراع على الهيمنة الإقليمية.
وكان هذا أحدَ المحاذير الرئيسية التي أشرت إليها في وقتها، من استفراد حماس بالسلطة فيها، حتى لو استند ذلك إلى الشرعية الانتخابية والقانونية الفلسطينية.
وقد أظهرت السنوات القليلة الماضية المردود العكسي لاستفراد القوى الإسلامية بالسلطة ونتائجه السلبية، فالحركات الإسلامية عموما، منتجة في المقاومة، ربما أكثر من الحركات القومية أو الوطنية أو العلمانية.
فهي تحظى برصيد من العطف الشعبي يقوم على قاعدة قوية من الأفكار والاعتقادات والرموز التي بقيت وحدها حية بعد الزلزال الذي أصاب الأيديولوجيات الكلاسيكية اليسارية والليبرالية في مجتمعاتنا.
لكن هذه الحركات غير منتجة -بل ذات نتائج معاكسة- في الحكم، لأنها تحرم الشعب الذي تحكمه من أي هامش مناورة أو مبادرة سياسية على الساحة الإقليمية والدولية معا.
فالعالم كله -بحكوماته ورأيه العام- معبأ ضد الحركات الإسلامية التي يطابق بينها وبين العنف والإرهاب والتعصب والردة إلى الماضي والظلامية.
وليس هناك أي فائدة في أن تحمل القضية الوطنية لأي شعب عبء هذه الصورة المروعة التي نجمت عن وقائع جزئية فعلية، مثل ممارسات بعض فرق السلفية الجهادية، لكن بشكل أكبر عن عملية غسل الدماغ المتواصل والواسع النطاق التي مارستها أجهزة الإعلام وبعض المثقفين الغربيين أيضا على الرأي العام العالمي.
ولذلك عندما تستلم حركة إسلامية الحكم لا تدفع إلى عزل الشعب الذي تريد أن تقوده -حتى لو كان مجمعا عليها- عن العالم فحسب، وهذا ما حصل لغزة حتى على المستوى العربي، وهو ما يحصل لإيران وما حصل لأفغانستان وللسودان من قبل.. وإنما أيضا تجعل من مهاجمته ومعاقبته هدفا للنظام الدولي بأكمله.
وهذا ما يفسر ضلوع هذا النظام الدولي الفعلي مع القنابل الإسرائيلية التي تسقط على شعب غزة، إلى درجة سوّى بيان الأمم المتحدة فيها بين العنف الإسرائيلي وعنف حماس، وبرر بصورة غير مباشرة العدوان الإسرائيلي باعتباره نوعا من رد الفعل.
أقصى ما يمكن أن ننتظره للأسف من الرأي العام العالمي اليوم هو أن يقول إن العنف الإسرائيلي لا يتناسب مع العنف الفلسطيني. لكن من وراء كل ذلك ضاعت القضية الرئيسية التي تتجاوز العنف من أي طرف جاء، وأعني قضية الاحتلال.
والحال أن ما ينبغي علينا أن نفعله هو تجنب كل ما من شأنه أن يغطي على القضية المركزية في النزاع العربي الإسرائيلي، وهي قضية الاحتلال، والاستعمار المرتبط به، ولا نقدم لإسرائيل وأبواقها الدولية القوية ما يساعدها على التشويش على الرأي العام الدولي.
وبالمثل، لا بد لنا من مراجعة إستراتيجية المقاومة اليومية، فلا ينبغي استخدام العنف الشرعي والمشروع الذي يخوله لنا حق الدفاع عن النفس وطرد الاحتلال للتنفيس عن الغضب وإلهاب المشاعر والتغطية على الشعور بالعجز واليأس والإحباط، وإنما أن نوفره للاستخدام الناجع ضمن رؤية إستراتيجية وخطة مقاومة منظمة وطويلة النفس تهدف إلى فضح الاحتلال وتعريته واقتلاعه. فليس المطلوب مقاومة تعبر عن الوجود وإنما تغير الواقع الموجود، وتبديل الأوضاع السلبية القائمة.
وهذا يحتاج إلى تغليب النظرة العملية أي المحققة للنتائج على الأرض، لا المنفسة عن مشاعر الغضب، كما يحتاج إلى بلورة خطة عمل للمقاومة تتجاوز رد الفعل على الاعتداءات الإسرائيلية، تؤلف بين أوسع قطاعات الرأي العام الفلسطيني، كما يحتاج إلى ضمان الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوسيع هامش مبادرة الشعب الفلسطيني السياسية في المنطقة وعلى الساحة الدولية. ولا يمكن لقيادة مطبوعة بالصبغة الدينية مهما كان إخلاصها للقضية وحماسها لها، أن تحقق هذه الشروط في الظروف الراهنة. لكن بإمكان مثل هذه الحركة أن تلعب بامتياز دورا مركزيا في المقاومة، وتترك لقوى أخرى وطنية جامعة، مسألة قيادة سلطة لا تزال -مهما كابرنا على أنفسنا- تستمد شرعيتها من الاحتلال وتتبع له عمليا في كل شيء.
7- لم تعد هناك اختيارات كثيرة اليوم، فقد قطع العدوان الإسرائيلي الراهن الذي جاء تتويجا لإخفاق محادثات رأب الصدع الفلسطيني واستفاد منه إلى حد كبير، الطريق أمام أي تفاهم بين حماس وفتح.
فكما أصبح من الصعب على حماس أن تقبل بما كانت ترفضه من قبل من دون أن تعطي ثمنا للعدوان، أصبح من الصعب على السلطة الفلسطينية التي أخفقت هي أيضا في الحفاظ على وحدة الصف بسبب سياساتها العصبوية، وفساد جزء كبير من كادرها واستقالتها السياسية، في أن تقبل بما سيترجم من قبل إسرائيل على أنه إعادة الاعتبار لحماس وسلطتها في غزة.
أفضل ما يمكن أن تفعله حماس أن تعمل على إعادة بناء السلطة في غزة على أسس جديدة تضمن التعددية السياسية ومشاركة كبيرة لقوى وطنية مستقلة، على طريق التمهيد لمفاوضات جديدة مع السلطة في الضفة، لا من أجل تقاسم المناصب مناصفة، وإنما من أجل توسيع مفهوم حكومة الوحدة الوطنية التعددية، وتعميمها على جميع المناطق الفلسطينية.
ولن يتحقق ذلك إلا على حساب فتح وحماس واستفرادهما بالقضية معا، وبقبولهما الطوعي بتقليص وزنهما في الحكومة الموحدة القادمة، ودفع ثمن النكسة الخطيرة التي أصابت القضية الفلسطينية في السنتين الماضيتين.
ولا أزال أعتقد بأن من مصلحة حماس والقضية الفلسطينية أن تعف عن الانفراد بالسلطة، وأن تفاوض على نجاحها الانتخابي مقابل تأليف مثل هذه الحكومة الوطنية الواسعة التي لا تبقي السلطة احتكارا لفتح أو لفريق محمود عباس، ولا تقسمها بين فريقين متنابذين وتقسم فلسطين المحتلة معها.
هذا هو طريق التفاهم الوطني مع ضمان الغاية الرئيسية منه، وهي أمران مترابطان ومتكاملان: توسيع قاعدة الحركة الوطنية والوحدة الفلسطينية من جهة، والحفاظ على خط المقاومة للاحتلال من جهة ثانية. وكل ما عدا ذلك ينبغي أن يخضع لهذه الغاية ويصب فيها.
هذا يعني أن الحل قائم عند الفلسطينيين أنفسهم، وليس في أي مكان آخر. ولا تجدي المراهنة على الأطراف الخارجية مهما كانت، عربية أو دولية. فإذا رفض الفلسطينيون أن يقوموا بواجبهم تجاه قضيتهم، فلن يقوم بهذا الواجب أي طرف آخر عوضا عنهم. وإذا لم يقتنع الفلسطينيون بضرورة العمل جبهة واحدة للاحتفاظ بمقدرتهم على مقاومة الاحتلال، فلن تفيدهم وساطة أحد ولا ضغوطه ولا تأييده.
فلا يتدخل أي طرف من الأطراف العربية والإقليمية إلا لخدمة مصالحه السياسية والإستراتيجية، ولن يكون حافزه سوى استغلال النزاع الفلسطيني الفلسطيني من أجل تحقيق أهدافه الخاصة.
ولا يعني توسيط هذا الطرف الخارجي أو ذاك -سواء أكان الطلب من قيادة فتح أو حماس- سوى التهرب من استحقاقات الاتفاق الجدي والتمسك بالسلطة، حتى لو كانت على حساب القضية الوطنية وعلى أنقاضها